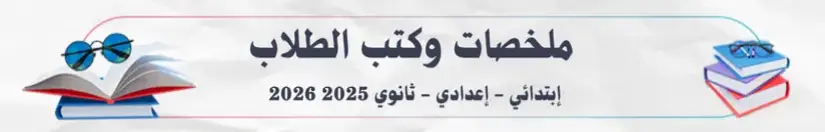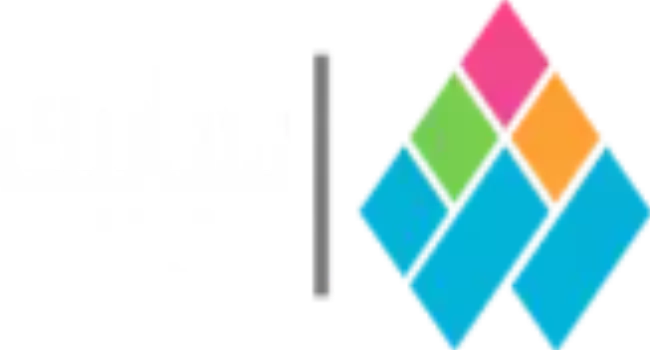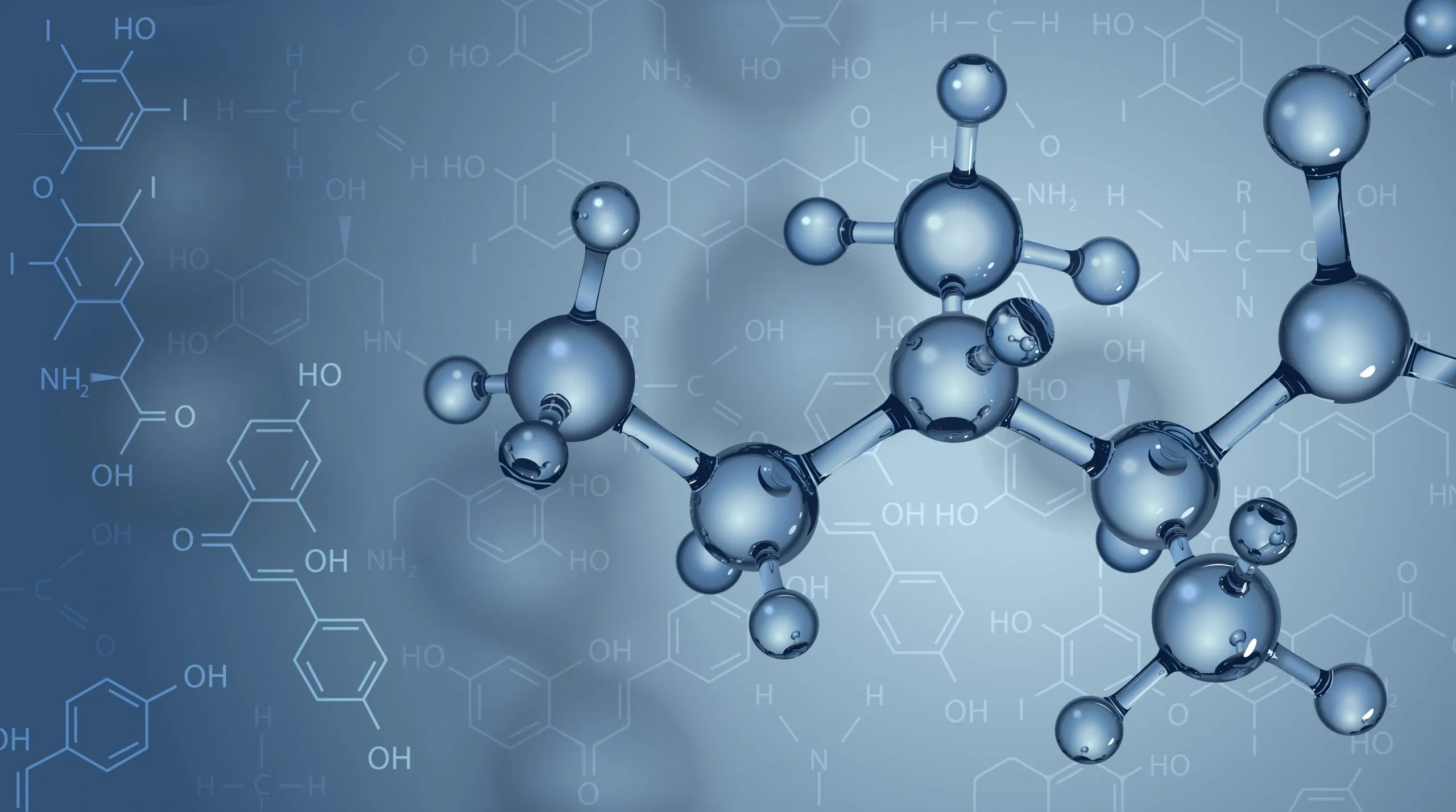بسمة حسن تكتب: والنبي ناولوني السماعة
«والنبي ناولوني الولاعة عايزة أولع روما بحالها»، جملة أضحكتنا جميعًا ومازالت تضحكنا في فيلم «المليونير»، لنجم الكوميديا الذي لا يتكرر إسماعيل ياسين، وللمفارقة المبكية المضحكة أنها كانت ضمن اسكتش داخل مستشفى المجانين، من منا لا يتذكر هذا المشهد.
ربما هذا ما يدور الآن في أذهان كثير من الشباب، والنبي ناولوني الولاعة عايز أولع – بس مش روما بقى – لا دي الدنيا بحالها، ولكن لأن التعبير عن تلك الرغبة محض «طق حنك» كما يقولون، فإنها تتوقف عن كونها رغبة دفينة ولا تجد لها سبيلًا سوى في أعماق اللاوعي الذي يبحث دائمًا عن حلول للتنفيس عن رغباتنا الشريرة غير المرئية، فإذا به في هذه الحالة يجد ضالته في السماعة.
هتقولي: إيه ده؟ عمق ولاوعي ورغبات شريرة؟ والحوار كله عن السماعة؟ أقولك أيوه ياكبير. من منا اليوم لا يرتدي السماعة؟ حتى إن الأمر لم يعد متوقفًا فقط على الشباب، نعم بدأ بهم، إلا أنني اليوم أصبحت أرى أيضًا الكبار الذين كانوا ينتقدوننا لكثرة ارتدائها، يلجأون إليها ويرتدونها هم الآخرون، ربما هم أيضًا صبرهم بدأ ينفد.
الظاهرة شغلت بالي لفترات طويلة، فقد أصبحنا بالفعل مجتمع سماعات بجدارة، فالجميع يرتديها في الشوارع الطرقات، في الجامعات والمدارس، في المترو والمواصلات، في السوبر ماركت والمولات، وكذلك في العمل وفي المنزل أيضًا، صباحًا ومساءً وحتى قبل النوم، فقد أغلقت الآذان جميعها.
وعندما جلست متأملة أسأل نفسي عن أسباب ذلك، ولماذا وجدنا ضالتنا في السماعة؟ وجدت أن جميع الإجابات التي خطرت على بالي منطقية تمامًا. الزحام والضغوط النفسية والأزمات المالية والتزامات العمل وأعباء المنزل وكثرة المسؤوليات، حتى الاحداث الداخلية والعالمية لتي تخرق آذاننا يوميًّا عبر التليفزيون والراديو أو حتى الأخبار التي تزدحم بها مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تصب في رؤوسنا فتثقلها وتهوى بنا جميعًا في براثن الاكتئاب ودوامة الروتين اليومي القاتل والأحداث الضاغطة.
فالشباب - وأنا من بينهم – أصبحنا وكأننا الآن إسماعيل ياسين نرى العالم مستشفى للمجانين، من منا الآن لا يصيبه الهلع الكوميدي عندما يكتشف أنه خرج من منزله دون سماعته الحبيبة؟ فهو الآن أصبح مباحًا مستباحًا في كل مكان ومن أي شخص، فهذه مشاجرة في الشارع تصطدم أذنه فيها بألفاظ بذيئة، وهذه فتاة صعدت لعربة السيدات في المترو، فإذا بسيدتين بجانبها ينهران بعضهما بعد طلب إحداهما للأخرى، قائلة: «لوسمحتي ماتزقيش»، الباعة الجائلون وأصواتهم المرتفعة وإلحاحهم الذي لا ينتهي.
القائمة طويلة ولا تخلو من المواقف الهستيرية، فهؤلاء مجموعة من زملاء العمل يعتقدون أنه مكان للتنزه وتبادل الحديث في أذنك، وهذا سائق ميكروباص كل ما يشغله امتلاء الصف الأخير بأربعة أنفار والاطمئنان على الأجرة، «توك توك» يسير بجانبك تطفح منه أصوات المهرجانات، فكلها طقوس يومية تبعث على الجنون.
أليست السماعة حلًّا مناسبًا لهذه المأساة حتى ولو بدت حلًّا بسيطًا تافهًا يقف أمام تلك المواقف؟ فأنت بها ملكزمانك ومكانك، يمكنك الانتقال بها عبر الموسيقى أو أي شيء آخر للمكان والزمان الذي تريد، ان تنعم بمساحتك الشخصية ولو بهذه اللحظات التي تختار فيها الامتناع عن سماع ما لا تريد، منفصلًا عنكل ما يدور حولك، أن توقف صوت العالم قليلًا لتنعم ببعض الصمت، فهذا أحيانًا كل ما تبحث عنه.
على الأقل ستجعلنا بدلًا من اللجوء للولاعة، نكتفي بقول: «والنبي ناولوني السماعة».