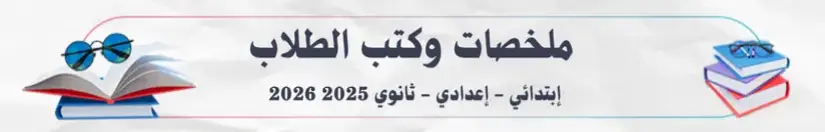علي الكسار.. «بربري المسرح» الذي دفن ابنته وذهب ليُضحك الجمهور
ليس أدل على نجاح الفنان في مجال التمثيل من اعتقاد الجمهور أن الدور التي يجسده هو شخصيته الحقيقية. حدث ذلك مع علي الكسار الذي ظن كثيرون أن شخصية «عثمان عبد الباسط» العفوية التي جسدها في أعماله هي شخصيته في الواقع.
وبحسب أمل عريان فؤاد في كتابها «الضاحكون الباكون» كان من الذكاء أن يختار «الكسار» هذه الشخصية التي استطاعت أن تقربه إلى الفئات الشعبية، فقليلون من يعرفون أنه ليس نوبياً أو بربرياً.
ومن خلال شخصية «البربري» استطاع «الكسار» أن يلعب دوراً في تحرير المسرح المصري من أسر المسرح الأوروبي، أي تمصير المسرح بدلاً من اعتماده على الأعمال الفنية الغربية.
كما استطاع «الكسار» من خلال مسرحه أن يلعب دوراً وطنياً خلال ثورة 1919، فانحاز بمسرحه إلى الشعب بعد أن كانت روايات الفرانكو آراب تطغى على المسرح المصري طوال سنوات الحرب العالمية الأولى.
سروجي وسفرجي
ولد «الكسار» في حي المغربلين بالقاهرة في 13 يونيو 1887 لأب يعمل سروجي. واسمه الحقيقي هو علي خليل سالم، أما لقب «الكسار» فهو لقب والدته «زينب علي الكسار»، وقد أضافه إلى اسمه مع بداية اشتغاله بالفن اعترافاً منه بجميلها لأنها ساندت موهبته كثيراً خاصة بعد رحيل الأب.
لم يتلق «الكسار» أي قدر من التعليم، وحاول والده تعليمه مهنة السروجية إلا أنها لم ترق له، فقد كان نظره مُنصرفا مهنة السفرجية بسبب حبه لخاله الذي كان يعمل بها، فبدأ يجالس الطهاة وتشرّب منهم عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم أيضاً. ومن خلال تلك الأجواء نمت بداخله براعم شخصية «عثمان عبد الباسط» بربري مصر السينمائي الوحيد.

لم تمنعه «السفرجية» من تنمية موهبته الفنية حتى جاء عام 1907 فشارك في بعض العروض المسرحية وأصبح حديث الناس بسبب «قفشاته» المضحكة، ومن هنا بدأت رحلته الحقيقية مع الشهرة ، فشارك في مسرحية «حسن أبو علي سرق المعزة» وقام بدور خادم نوبي يتصرف تصرفات تلقائية.
لعبت الصدفة دوراً في إسناد هذه الشخصية إلى «الكسار». وكان من المفترض أن يقوم الفنان عثمان أمين بهذا الدور وكان من المقرر أن يقوم بصبغ وجهه باللون الأسود، إلا أنه خاف على وجهه وعينيه من تأثير الصبغة، فما كان من على الكسار إلا أن تقدم وصبغ وجهه وعرض تمثيل الدور، ليكون ذلك سبباً في شهرته.
اشترك «الكسار» بعد ذلك مع الفنان مصطفى أمين في فرقة «جوقة الأوبريت الشرقي» ثم انفصل عنه، وكوّن فرقة تحمل اسمه كانت تقدم عروضها في شارع عماد الدين. أغرى نجاح «الكسار» أحد اليونانيين أن يقيم له مسرح «ماجستيك» مقابل الحصول على نسبة من الإيراد. افتتح المسرح عام 1919 برواية «القضية رقم 14»، وعبّر «الكسار» خلالها عن أوجاع الطوائف الشعبية المقهورة، وطالب برفع الظلم عنها.

عالم السينما
بدأ «الكسار» مشواره مع السينما وهي لا تزال صامتة، ليقدم أول أعماله في 5 مايو 1920 من خلال فيلم قصير من فصلين بعنوان «الخالة الأمريكية» والمأخوذ عن الرواية الإنجليزية الشهيرة «عمة تشارلي».
ورغم تحمس «الكسار» للسينما مبكراً إلا أنه بعد تقديمه لهذا الفيلم فقد حماسه لها، ليظل بعيداً عنها حوالي 15 عاماً. وعاد إليها في عام 1935 بفيلم «بواب العمارة»، ثم «غفير الدرك» عام 1936 والذي نجح نجاحاً غير مسبوق وكان سبباً في تقديم عدد من الأفلام المتتالية مع المخرج «توجو مزراحي» فصنع معه أهم أفلامه، منها «100 ألف جنيه»، و«التلغراف»، و«الساعة 7»، و«عثمان وعلي»، و«سلفني 3 جنيه»، و«على بابا والأربعين حرامي»، و«نورالدين والبحارة الثلاثة».
ورغم أن شخصية «عثمان» كانت سر نجاح علي الكسار وبزوغ نجمه، فقد كانت أيضا السبب في انصراف الجمهور عنه حيث ظل أسيراً لها ولم يستطع أن يطور من أدائه ليتناسب مع متغيرات المجتمع، وكذلك ظهور أبطال وفنانين للكوميديا استطاعوا أن يرسموا ملامح الكوميديا السينمائية الجديدة أمثال إسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسي.
لذا سرعان ما انحسرت عنه الأضواء ليقدم أدوراً ثانوية لا ترقَ لأدوار البطولة التي بدأ بها أعماله السينمائية مثلما حدث في فيلم «رصاصة في القلب».

نهاية المشوار
سقطت ورقة علي الكسار في 15 يناير عام 1957 أثناء إجراءه لجراحة في المسالك البولية في مستشفى قصر العيني.
لم يكن «الكسار» في حياته الشخصية كما في أعماله حيث الرجل الهزلي عثمان عبد الباسط، بل كان على النقيض تماماً. كان جاداً في حياته وحازماً وصارما ومهاباً، وكان صورة نموذجية لشخصية «سي السيد» في منزله ومع أهل بيته.
وبالرغم من تكوينه لثروة كبيرة إلا أنه ظل محتفظاً بحياته البسيطة، فلم يكن يتظاهر بأمواله وثرائه، وظل يحيا بعيداً عن المظهرية والتكلف، فظل قاطناً ببيته في حارة النجار بالحمزية، محتفظاً بركوبته المحببة وهي عربة الحنطور، رافضاً استخدام السيارة.
عاش «الكسار» حياته كشمعة تحترق من أجل الآخرين معتزاً بفنه وبما يقدمه مهما بلغت به المآسي، ولعل إصراره على تقديم عمله المسرحي في نفس يوم وفاة ابنته «أحلاهم» خير دليل على عظمة ذلك الفنان الذي دفن ابنته في الصباح، بينما كان في المساء على خشبة المسرح يقدم الضحكة والابتسامة بقلبه الذي يقطر حزناً وألماً. وفق ما تضف أمل عريان فؤاد في كتابها الضاحكون الباكون.