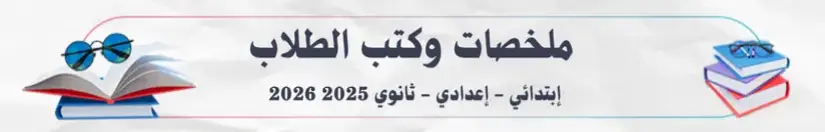دعاء نبهان تكتب: دراسة نادين لبكي الاجتماعية
كانت السيدة الجالسة بجانبي تبكي في صمت.
تململت في مقعدي قليلاً لا أعلم كيف أشعر حيال بكائها الصامت!
تزداد مشاهد الفيلم سخونة ويعلو بالتبعية صوت بكاء السيدة..
امتلأت الشاشة بوجه زين، بطل آخر أفلام نادين لبكي «كفر ناعوم»، نظراته التي يعلوها الأسى، وجهه الجذاب، شعره الناعم، وجسده الضئيل.
زين طفل لبناني من عائلة فقيرة، يضجّ منزله المهلهل الضيق القذر بالأطفال، الأخوة والأخوات من كل الأعمار، يفترشون الأرض، ينامون متلاصقي الأجساد، يرتدون من الملابس المتسخة ما يغطي أجسادهم النحيلة بالكاد ويأكلون الفتات.
يساعد «زين» والديه بالعمل؛ بشكل يومي في محل يملكه صديق الأسرة، وبشكل متقطع في تجارة الأقراص المخدرة، سواء في التحايل لجلبها أو توزيعها بعد طحنها وخلطها بالماء، مما يعرضه لخطر يومي جسيم ومضايقات وتحرشات مستمرة.
«زين» على علاقة قوية وخاصة بأخته سحر، طفلة في الثانية عشر من عمرها، تساعده في بيع العصير في الطرقات وتعيش حياتها كطفلة تسعد بالحلوى وتتغذى بأكل شعرية «الإندومي». يقرر «زين» الهروب من المنزل فور علمه بأن والديه قررا زواج سحر «الطفلة» من الشاب رب عمله، مقابل حفنة من الأموال وبضع فرخات.
هكذا رسمت نادين لبكي مقدمة القصة، تفاصيل صادمة مقززة لواقع حزين وبشع.
تستمر القصة في سرد رحلة معاناة «زين» بعد هروبه من المنزل وتعرفه على الخادمة الأفريقية «رحيل» التي تقيم بشكل غير قانوني في البلاد، تسكن في عشوائيات من علب صفيح مع طفلها الرضيع غير الشرعي «يونس». تحنو على «زين» وتأويه معها، ليستكملا معا رحلة الكفاح من أجل البقاء.
بالتوازي، تستمر نادين لبكي في إبهارنا بصريا بتصوير بديع، أبطال وممثلين ذوي كاريزما أخاذة، توظيف ذكي للأماكن والتفاصيل الحادة، وموسيقى مميزة تستفز المشاعر وتستدر الدموع!
تظلم الشاشة وتضاء الأنوار، أنظر بجانبي للسيدة الباكية لأجدها تجفف دموعها وتحاول تمالك نفسها. أتأملها للحظات: سيدة أيرلندية خمسينية العمر، متوسطة الطول، شقراء الشعر، أنيقة اختارت ملابسها بعناية، جاءت لتشاهد الفيلم بمفردها، تحمل عدد من ملصقات الأفلام والكتيبات الخاصة بمهرجان السينما القائم بمدينة دبلن حيث أعمل وأعيش.
ملت عليها لأسأل: يبدو أن الفيلم أعجبك!
= نعم.
- لماذا؟
صمتت للحظات وتأملتني لوهلة تفكر ثم قالت بوهن:
= تأثرت من قصة الصبي المسكين والخادمة الإفريقية وحياتهما البائسة.
- وما شعورك الآن؟
= أشعر بالذنب. وأشعر بالغضب تجاه والديّ زين؛ لا يجب على أمثالهما إنجاب الأطفال!
- ولكنك تعاطفتي مع الخادمة وطفلها الرضيع وتمسكها به، على الرغم من أن ظروفها ليست أحسن حالا من والدي زين؟!
سكتت للحظات وتمتمت بتفكير:
= نعم.
- لماذا؟
= لا أعرف!
تعاطفت مع حيرة السيدة اللطيفة ورافقتها إلى خارج القاعة حيث الساحة يضج أغلبها بالعرب من كافة الأعمار، جاءوا ليشاهدوا الفيلم اللبناني/العربي الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان، وترشح كأحسن فيلم أجنبي في أغلب منصات الجوائز الأمريكية، أكثرها شهرة جائزة الأوسكار.
تحدثت مع هيلين – السيدة الأيرلندية- عن أسباب صدمتها وهل فوجئت بوجود الفقر والجوع في العالم، لتنفي قاطعة جهلها بتلك الحقيقة المُرة، ولكن لتؤكد أن الصور والمناظر في الفيلم كانت أكبر من خيالها المحدود أو مما تنقله الشاشات الإخبارية للعالم الغربي على عجالة.
- وهل اقتنعتِ بالحكاية؟
= ردت السيدة بحيرة: ما هي الحكاية؟
نعم، انشغلت السيدة نادين بتقديم البؤس ممثلا في أحداث مأساوية متفرقة، دون أي رابط درامي أو حبكة تصدق، عن مواجهة الواقع وتحايل «زين» بذكاء لتحدي الصعاب. في رحلة متلاحمة من المشاهد القوية والكادرات المميزة، لتخلق دراما بصرية آسرة.. دون تقديم الجديد أو المختلف. ولكن أين الحكاية؟ أين رسم الشخصيات بطبقاتها المعقدة وتاريخها المؤثر؟
أختارت نادين لبكي في فيلمها أن ترتدي عباءة المستشرق الأبيض، الذي يجوب حارات وعشوائيات العالم الثالث، يلتقط الصور ويسجل لحظات الشقاء، قد يرتدي جلباباً أو طاقية ليندمج «ظاهريا» مع الناس، يلهو مع الأطفال ويتحدث معهم، ويذوق من الأكل الشعبي ويحبه، ثم يعود لبلاده بحصيلة مرئية وأرشيف مصور للمعاناة والبؤس، قد يشاركها مع أصدقائه أو يقيم عليها الدراسات وحلقات النقاش، دون فهم، دون وعي أو اتصال حقيقي بالمنظومة الاجتماعية والبشر؛ لتقدم فيلما يمكن وصفه بالدراسة الاجتماعية، بطريقة «محمد صبحي» في المباشرة وتقديم المواعظ، مقدمة للغرب المغيب؛ لتكشف له حقيقة الوطن العربي، معاناة الجهل عند اتحاده مع الظروف الاقتصادية المستحيلة.
ثم تحكم حكمها النهائي على كل من تسوُّل له نفسه تنشئة أطفال في بلادنا الفقيرة. تشحن طاقة التعاطف، تفجر الدموع، تستخرج الآهات ويعلو النحيب صالات السينمات الغربية والأمريكية، ليقف الجميع بعد الفيلم مصفقا للحكمة الختامية العظيمة و«الجديدة»، ألا وهي:
«أيها الفقراء، توقفوا عن الإنجاب في هذا الوطن الحزين المنكوب» وليخرج الجميع يجفف دموعه ويردد صلوات الشكر والعرفان بالجميل، لأنه لحسن حظه وُلد في الجانب الغني من العالم، ولربما أرسل بعض النقود لصناديق إطعام الفقراء، ليريح ضميره وينام ليلاً نوما هنيئاً.
مسحت السيدة دموعها وهندمت شعرها وقالت بحسم:
= قرأت أن الولد البطل لاجئ سوري وبفضل الفيلم استطاع الانتقال بأسرته إلى السويد للعيش هناك. على الأقل هذه نهاية سعيدة للحكاية الحقيقية!
- نعم، نهاية عادلة.. لمن نجح الفيلم بسببه.