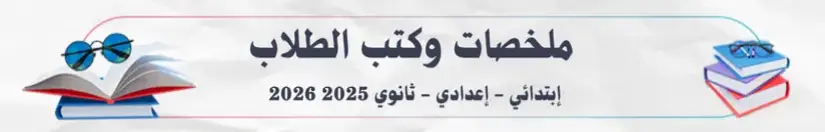حسام مصطفى يكتب: لكن النبي محمد.. «باشا» فعلا
أثار منشور، أوردته دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية، احتفاء بيوم ميلاد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، عدّدت فيه صفات الرسول، جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدام كلمة «باشًّا» -بشوش الوجه ضحوكًا- التي لم يفهمها بعضهم، وحسبوها “باشا” التي نتداولها فيما بيننا، ولاموا على مسؤول الصفحة وصف النبي الكريم بهذه الصفة العصرية للغاية، وطالبوه بأن يتّقي الله!
وهو ما يطرح إشكاليتين:
الأولى: قلّة الثقافة، والغُربة الحاصلة بيننا وبين الألفاظ العربية، ما يؤدّي –مع الوقت- لغموض بعض الكلمات، وربما فقدانها معانيها نهائيا، حتى لو لم تكن صعبة، أو بعيدة في زمن تأليفها.
الثانية: دورة حياة الألفاظ، وتحوّل معانيها بمرور الزمن.
فالكلام الذي نشره مسؤول صفحة الإفتاء، منقول من كتاب (زهرة التفاسير)، لمؤلفه محمد أبو زهرة، المتوفّى منذ 43 عاما تقريبا، أي إنه ليس قديمًا للغاية، بحيث يصعب فهمه، أو إساءة تفسيره، لاستخدامه قاموسا عفى عليه الزمن، إنما هو بشكل أو بآخر، معاصرٌ لنا، ولغته حية وحديثة، مع ذلك، وجد الغالبية مشقة كبيرة في استيعاب كلامه، ما يعني أن وتيرة فقداننا اللغة، تسير بأسرع مما نتخيّل، وربما تصل بنا في لحظة من اللحظات، لعدم فهم أحدنا الآخر نهائيا!
والحفاظ على اللغة، ليس ترفًا ولا “فذلكة” ولا نُخبوية، وإنما حفاظٌ على الهوية، وعلى وجود أرض مشتركة، نقف عليها جميعا في النهاية، ونتمكّن من التواصل الفعّال، وفهم أحدنا الآخر، لقضاء حوائجنا وإعمار الأرض.
النقطة الثانية، أن اللغة، كائن حي، يتطوّر وينمو، ويتعايش مع المصطلحات التي تجدّ، ويحتويها، ويدمجها في بنيته، ويعطي لها دلالات جديدة، ومعاني ربما لم تكن لها في بدايتها، وإلا مات واندثر، كما أنه يحافظ كذلك على ثوابته، وأصوله، كي يكون له ماضٍ يلجأ إليه، وجذور تثبته في الأرض، كما يسعى أن يكون له مستقبل، فالماضي والحاضر والمستقبل محطات يتحرّك فيها كائن اللغة بسلاسة، كي لا يموت.
وعليه، فكلمة باشا، التي قيل إنها تركية، كانت في فترة الدولة العثمانية لقبًا يمنحه السلطان العثماني للسياسيين البارزين، والجنرالات والشخصيات المهمة والحكّام، وهو ما يعادل لقب “لورد” الإنجليزي، وألغي بإقامة الجمهورية في مصر.
ويقال إن الأيوبيين أول من استخدم اللفظ، كمرتبة شرفية لمماليكهم، وكان يعني “حامل حذاء السلطان” أي إنه يلازم السلطان في كل مكان ويقدّم له خدماته، وهو ما كان يعتبر شيئا مشرفا يباهي به المماليك، ومع الوقت، تطوّرت اللفظة، واختفى أصلها الفارسي، وبقي شبهها باللفظة التركية، التي تعني كبير وهي “باش”.
وفي استخدمانا المعاصر، تعني الكلمة: الكبير، أو صاحب الشأن، أو من يقدّم خدمة مهمة لنا، فنشكره بهذا اللقب.
إذن، فلا حرج ولا إثم على الإطلاق، من وجهة نظري، لو قلت على النبي محمد اليوم “باشا”، بلغتنا المعاصرة، قاصدا أنه رجل كبير المقام، وخدوم، وله أفضال علينا جميعا، تستحق أن نجلّه ونبجّله. الدين أوسع من الوقوف عند شكليات لا تعني أحدًا، والله أكبر من ألا يفهم مقصدنا، وهو من خلقنا وركّبنا وصنعنا على عينه.
ولو كانت باشا معروفة أيام النبي، لكان الصحابة قد أطلقوها عليه بلا أي حرج.
الأمر يشبه كلمة “فنّان” التي من أحد معانيها “الحمار المخطّط”، والتي تطوّرت مع الوقت، واكتسبت معاني جديدة، فأصبحت علامة على المشتغلين بالفن، وفي العصر الحديث، إذا قلت الفنان فلان، فلا يمكن أن يخطر ببالك المعنى القديم للكلمة، وتفهم أن المقصود بها الحمار الوحشي، فكثرة دوران الكلمة على الألسنة بمعناها الجديد، تحول دون اللبس، أو الفهم الخاطئ.، وتجعل من السهل فهم ما تقصده.
وأذكر حادثة طريفة، رواها الكاتب الجميل عمر طاهر، عندما زار قبر رسول الله، ووجد رجلا بسيطا يقف أمام المقام في هيبة، ولا يجد ما يقوله، انعقد لسانه من العظمة، وخشع قلبه من الرهبة، حتى فرّت حروفه ولم يعد يدري ما عليه أن يفعل، وعندما أحس أن المقام طال به ولم ينطق، تحرّك لسانه بعفوية وبراءة، ورفع يده أخيرًا جوار رأسه بعلامة السلام، وقال الكلمة التي اعتبرها مرادفا للتقدير والاعتراف بالفضل: باشا.
فهل يمكن أن تتّهم هذا الرجل بقلة الأدب مثلا، أو الجهل بمقام النبي، أم تحترم تلقائيته وبساطته وتضحك من قلبك لبراءته وصفاء قلبه؟
فالأولى من الوقوف عند الصفات والمعاني، أن نقف عند الأفعال والتصرفات.
فهل أدّى من اعترض على المنشور، تعصبًا لرسول الله، حقّ الرسول عليه، صلاة وصياما وأعمال بر واتقاء لله، أم أنه اكتفى بما هو سهل، وفي متناول يده، فكتب كلمتين على لوحة مفاتيحه، وقام بعدها ليكمل معاصيه وحياته التي لا يأتي فيها ذكر النبي إلا يوم مولده، مقترنا بالحلويات؟!
فلنرتب أولوياتنا.. أثابكم الله.