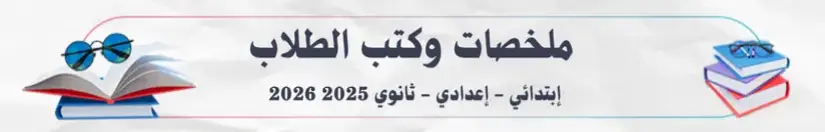عزة سلطان تكتب: لن يقرأ أبي هذا
ثمة أشياء نعرفها بعد مرور وقتها المناسب. تلك الحكمة التي نرددها ولا نقف لنتأملها، نمرر التفاصيل دون اكتراث، لا ننتبه للعلامات، ولا يشغلنا أن نفهم أبعد من موقفنا الحالي.
فى منتصف التسعينات كتبت قصة عنوانها «أرجو ألا يقرأ أبي هذا»، ورغبت أن تحمل مجموعتي الأولى نفس العنوان لكن أبي غضب واعتبر أن شيئًا يحدث دون علمه، كانت نظرته سطحية ككثيرين، وحلًا للأمر اخترت عنوان آخر.
على مدار سنوات عمري الأولي تعلمت الإنكار كابنة مخلصة للمرحلة، أسمع حكايات ولا أُصدقها.. تعلمنا أن يُبالغ الأهل في سرد بطولاتهم، وخزنا بداخلنا سخرية مما نسمع؛ لا شك أن حالة الإنكار هذه جعلتني أحتفظ بكل شهادات التقدير والبطولات التي حصلت عليها في مراحلي الدراسية.. كنت أخشى من تكرار حالة السخرية الداخلية، وكنت أود أن يكون أبنائي فخورين بي عن ثقة وليس عن مبالغة.
لماذا يكذب/يبالغ الأباء؟
إننا كبشر بحاجة لنقاط ضوء، ومناطق فخر حتي لو زيف.. نحتاج لصنع تاريخ شخصي، يجعلنا قادرين على إطلاق الأحكام، وإعلان جملة بطعم الحكمة؛ ستبدأ العبارة غالبًا بـ «أنا لما كنت في سنك ...». نحن الأباء بحاجة لأن نبدو مميزين أصحاب القدوة والرأي.. إنها السلطة الأبوية التي تري أن رعايتها للأبناء الزامية وأنهم (الأباء) قد امتلكوا ناصية المعرفة.
لم نتربَّ على الاعتراف بالخطأ، ورغم اليقين بعدم وجود شخص كامل، إلا أنها مجرد جملة يتم ترديدها، لكن لا أحد -إلا قلة- قادر على الاعتراف بالخطأ والنقيصة.
في قرارة أنفسنا نعرف أن أبنائنا لا يصدقون ما ندعي ورغم ذلك نستمر في جعل أنفسنا أبطالًا خارقين، نكذب ونحاسب أولادنا أنهم يكذبون.
نمتلك ثقافة الإدانة ولا نقف لنتعلم ثقافة الاعتراف بالخطأ، ولا الاعتذار، ثم نقف لنولول أن أولادنا عاقين.
أبي الذي لم أعرفه
ستبقى هناك دومًا هدية لم أشترها، ولم أقدمها له، كنت أستمع لحكاياته غير مبالية، غير مُصدقة أن رجل بكل هذه المواهب ينتهي به الحال موظفًا.. لم تكن مخيلتي تتسع لفهم طبيعة النفس والظروف، ولم يهبني أبي سوى الانتصارات. لم يحك تجربته كما مرّ بها، اكتفي بفقرة البطل الخارق، سمعت صوته الجميل، ورأيت يده ترسم كمحترف، وتعلمت جماليات الخط العربي وهو يكتب أمامي، ولم تكن كل موهبة من تلك تزيدني إلا إنكارًا، أراه غنيًا بما يملك فلماذا ضاقت به الدنيا؟
لسنوات طويلة تمتزج السخرية والإنكار بداخلي صوب كل حكاياته، لكن ذات يوم قرأت رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية» للروائي البديع إبراهيم عبد المجيد، قدمت الرواية كل حكايات أبي، بدت مثل صفعة على وجهي؛ راجعت كل لحظات الإنكار، حزنت وغضبت من نفسي، شعرت أنى لم أوفِ أبي حقه، ولم ينل التقدير الذي يستحقه فقد فارق قبل أربع سنوات من تلك اللحظة، كثيرًا ما تطهرت وأعلنت عن خطأي وضيق رؤيتي، وكثيرًا ما قابلته في الأحلام واعتذرت منه، لكن ظلت التجربة بعينى.
أسرعت أعترف بنقائصي لابنى، حكيت له اخفاقاتى قبل نقاط التميز، هذا ما نحتاجه بدقة أن نبدو بشرًا خطائين، ألا ننتحل صفات خارقة، وألا نخفي عيوبنا.
الأمر يحتاج شجاعة كبيرة، أن نقف ونُعلن أننا لسنا ملائكة.. من يمكنه أن يفعل ذلك؟
عزة سلطان تكتب: لكن دمي فاسد إلى حين
غض البصر!
كثيرون يغضون البصر عن عدم تصديق الآخرين لحكاياتهم، ويقفون مستكملين قصصهم الوهمية، بل أن بعضهم يأخذ في تصديق أكاذيبه، وتكبر أمراض النفس، لنقابل مهووسي شهرة، ومهوسين بالسلطة الأبوية، وكثير من صنوف المرض النفسي بدرجاته المتفاوتة، نعم كلنا مرضي بدرجة أو بأخري، كلنا ناقصين وقلة من يستطيعون الاعتراف أمام أنفسهم بنقائصهم وأخطائهم.
لكن الموضوع أكبر من الاعتراف أمام النفس لمحاولة اصلاح أو تعديل السلوك، إنما تتعدي نتائجه لما أبعد من الشخص، فكثير من أبنائنا يكبرون بحالة من الانكار لأهلهم، وكثيرون يتعلمون الكذب كصفة حياتية أصيلة، وآخرون لا يمتلكون ثقافة التقدير أو الاعتذار.
ونحن من مواقعنا المختلفة نُدين الأخلاق التي تردت، والشعب الذي تغير، والأوضاع الآخذة في الانحلال، وننكر أن كل منا لبنة في هذا التدني، نحن الذين لا نعترف حين نُخطأ، ونحن من لا نقول شكرًا عند تقديم أحد خدمة أو جميل، ونحن الذين بهتت الابتسامة على وجوهنا وصارت وجوهنا لافتة للتجهم.
نحن الأباء والأمهات الذين نبدو في مظهر أولي الأمر المنزهين عن الخطأ، الملائكة، الأبطال الخارقين.
عزيزي الرجل عزيزتي المرأة،
حين تُقابل أحدهم أو إحداهم في الشارع وتكون لك ملاحظة على سلوكه/ا أو أخلاقه/ا فأعرف أنه ميراث الأهل، فنحن لا نورّث أبناءنا مالًا وعقارًا فقط، لكننا نورثهم الأخلاق والسلوك الذي ندفع نحن ثمن مساوئه في كل لحظة.