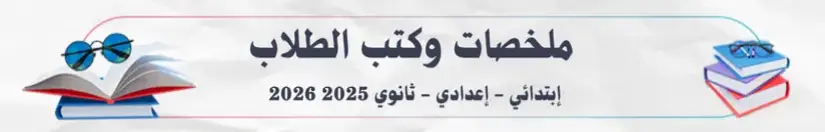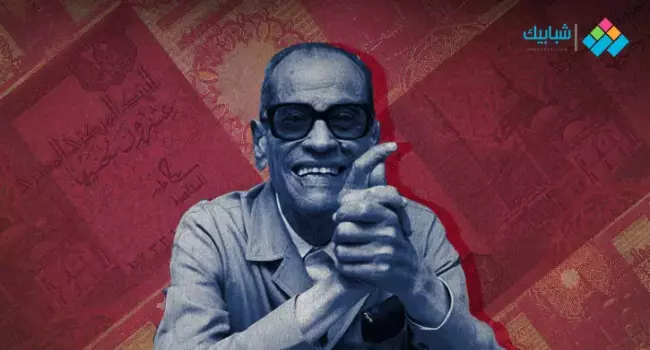نجيب محفوظ- المصدر: الإنترنت
حكايات نجيب محفوظ مع أمه والمتحف والحسين والدير.. مخزن الثقافة الشعبية
علاقة نجيب محفوظ بأمه لها خصوصياتها باعتبارها وضعت اللبنة الأولى في مفردات شخصيته وأفكاره التي تبلورت في أعماله فيما بعد. «شبابيك» يروى حكايات أديب نوبل مع أمه فاطمة إبراهيم مصطفى كما جاءت على لسانه في كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» للكاتب الراحل رجاء النقاش.
عشق الحسين
يقول «محفوظ»: كانت أمي سيدة لا تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك كنت أعتبرها مخزناً للثقافة الشعبية. كانت تعشق الحسين وتزوره باستمرار، وفي الفترة التي عشناها في الجمالية، كانت تصحبني معها في زياراتها اليومية، وعندما انتقلنا إلى العباسية كانت تذهب بمفردها، فلقد كبرت أنا ولم أعد ذلك الطفل المطيع، ولم يعد من السهل أن تجرني وراءها.
وفي كل المرات التي رافقتها فيها إلى سيدنا الحسين كانت تطلب مني قراءة الفاتحة عندما ندخل المسجد وأن أقبّل الضريح، وكانت هذه الأشياء تبعث في نفسي معاني الرهبة والخشوع.
والحقيقة أن عوامل عديدة ساهمت في أن أكون ملازماً لأمي طيلة الوقت. كان لي شقيقان وأربع من الأخوات، ومع ذلك نشأت كأنني وحيد أبويه، فكل إخوتي تركوا المنزل بعد أن تزوجوا، سواء منهم الرجال أو النساء وبقيت وحدي.
كنت أصغر الأبناء، وكان فارق السن بيني وبين الأخ الذي يكبرني مباشرة 10 سنوات، ولم يكن مقيماً معنا في المنزل، فهو التحق بالكلية الحربية، وبعد تخرجه أرسلوه إلى السودان وأمضى فيها عدة سنوات، وعندما عاد إلى مصر تزوج وترك البيت.
وكان كل أخوتي يقيمون في أماكن متفرقة وبعيدة، ونظراً لهذه الظروف كانت والدتي تحيطني برعاية كبيرة، وتصحبني معها في كل مكان تذهب إليه، سواء في زياراتها للحسين والمتحف والأديرة، أو في زياراتها لإخوتي المتزوجين.

المتحف والدير
والغريب أن والدتي كانت أيضاً دائمة التردد على المتحف المصري وتحب قضاء أغلب الوقت في حجرة المومياوات ولا أعرف السبب، ولا أجد تفسيراً لذلك، فحبها للحسين والآثار الإسلامية كان ينبغي أن يجعلها تنفر من تماثيل الفراعنة، ثم إنها كانت بنفس الحماس تذهب لزيارة الآثار القبطية، خاصة دير «مار جرجس» وتأخذ المسألة على أنها نوع من البركة.
ومن كثرة ترددها على الدير نشأت صداقة بينها وبين الراهبات، وكن يحببنها. وذات مرة مرضت والدتي ولزمت البيت، وفوجئنا بوفد من الراهبات يزورها في البيت، وفي ذلك اليوم حدث انقلاب في الشارع، لأن الناس لم يروا مثل هذا المنظر من قبل.
وكنت عندما أسألها عن حبها لـ«الحسين» و«مار جرجس» في نفس الوقت تقول: «كلهم بركة».. وتعتبرهم «سلسلة واحدة». والحقيقة أني تأثرت بهذا التسامح الجميل لأن الشعب المصري لم يعرف التعصب، وهذه هي روح الإسلام الحقيقية.
لكن زيارة والدتي للمتحف المصري والآثار الفرعونية لم يكن من منطلق ديني أبداً، لأنها كانت تعتبر هذه الآثار «مساخيط»، كما يسميها أهالي الجبل في الأقصر وسوهاج وأسوان.
ولا أجد تفسيراً لغرامها بالآثار القديمة، ففي أسرتنا سيدات تعلمن في مدارس أجنبية ويجدن اللغات الأجنبية والعزف على الآلات الموسيقية، ومع ذلك ليس لديهن ثقافة أمي أو غرامها بالآثار.
وإلى جانب عشقها للآثار كانت مغرمة بسماع الأغاني، خاصة أغاني سيد درويش، على الرغم من والدها الشيخ إبراهيم مصطفى كان شيخاً أزهرياً وله كتاب في النحو طُبع في المطبعة الأهلية.

وفاة الوالد
علاقتي بوالدتي كانت أوثق من علاقتي بوالدي لأسباب كثيرة، منها أن والدي كان مشغولاً، ودائماً كان خارج البيت في عمله، في حين أنني كنت ملازماً لأمي باستمرار.
وفي حين أن والدي مات عام 1937 عاشت أمي بعده سنوات طويلة، إلى أن تجاوز عمرها المائة عام، وتوفيت إلى رحمة الله عام 1968، وفي نفس السنة التي حصلت فيها على جائزة الدولة التقديرية، ولقد ظللت أعيش معها في منزلنا بالعباسية حتى تزوجت عام 1954، وجاءت شقيقة لي مات زوجها لتعيش مع أمي.
كانت والدتي تتمتع بصحة جيدة طوال عمرها، ولا أتذكر يوماً أنها ذهبت إلى طبيب في يوم ما، أو اشتكت من مرض ما، باستثناء العام الأخير من حياتها، حيث رقدت في سريرها وهي عاجزة عن الحركة تماماً.
ظلت أمي حتى حدود التسعين من عمرها تزور الحسين بشكل يومي، كما لم تنقطع عن زيارة أقاربنا، وكانت تحظى بمكانة وحضور كبيرين بينهم.
ورغم أنها عاصرت ظهور التليفزيون فإنه لم يدخل بيتها، بل لم تدخل السينما إلا مرة واحدة، لمشاهدة فيلم «ظهور الإسلام» بعد أن وصل إلى مسامعها أن من يشاهد هذا الفيلم يكون بمثابة من ذهب لأداء فريضة الحج، وبما أنها لم تتمكن من الحج ذهبت لمشاهدة الفيلم.
بيت جحا
كانت المنطقة التي عشنا فيها في الجمالية أشبه بـ«بيت جحا»، شوارعها معقدة وضيقة، ولذلك كانت والدتي تحرص على بقائي في البيت خشية أن تفقدني، فقد كان مألوفاً في ذلك الوقت أن تسمع صوت المنادي يبحث عن طفل تائه.
ونظراً لأن والدتي كانت من هواة تربية الطيور فقد تحول سطح البيت إلى عالم للحيوان، وكنت أفرح بهذه الطيور وأمتع الأوقات على السطح مع الكتاكيت والأرانب والدجاج. وأحيانا أمي كانت تسمح لي باللعب أمام البيت مع أولاد الجيران.
ولما زادت «شقاوتي» بعض الشيء اصطنع والدي معي الحزم، وبعد أن دللني حتى سن معينة، بدأ في سياسة الشدة، وأخيراً تخلص مني بأن أرسلني إلى «الكُتاب». صحيح أني كنت صغير السن ولا أفهم شيئاً، ولكن أهل البيت ارتاحوا مني، وعلى ذلك أستطيع القول بأنني عشت طفولة سعيدة لولا بعض المنغصات مثل «الكُتاب» والحزم وسياسة الشدة.
وعندما ماتت والدتي تبعثرت بين أيدي أفراد العائلة أوراق كثيرة وأشياء شخصية، ومن بينها صور خاصة بي، ولا أعرف ما هو مصير هذه الصور والأوراق وأين استقر بها المطاف.