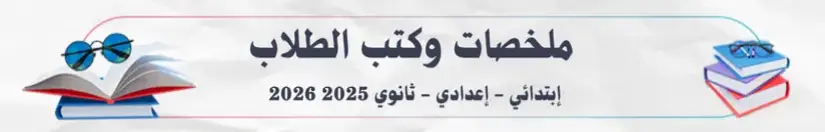دموع مي زيادة في مستشفى المجانين.. جانب آخر من حياة «معشوقة الأدباء»
في حياة الأديبة الراحلة مي زيادة جانب مظلم هاجمها في فترة عمرية معينة، وقادها لمصير لم تكن تتوقعه وقلب حياتها رأساً على عقب حتى انتهى بها إلى مستشفى للأمراض العقلية. القصة كاملة رواها رجاء النقاش في كتابه «عباقرة ومجانين».
ابنة وحيدة
اسمها الحقيقي ماري زيادة. ولدت سنة 1886، وكان أبوها إلياس زيادة لبنانياً، أما أمها فكانت فلسطينية من مدينة الناصرة واسمها نزهة معمر.
كانت «مي» هي الابنة الوحيدة لوالديها. تعلّمت في إحدى مدارس الراهبات في لبنان، ومنذ صباها تميزت بميولها الأدبية وحبها الشديد للمطالعة، فكانت تقرأ بنهم، واستطاعت أن تتعلم عدة لغات منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، فأتقنتها جميعاً وقرأت فيها آثار الأدب والثقافة.
جاءت «مي» إلى مصر سنة 1908 مع والدها ووالدتها، وكان عمرها 22 سنة. كانت فتاة ناضجة رشيقة جميلة، وصوتها عذب رقيق وصفه طه حسين عندما استمع إليها لأول مرة سنة 1913 عندما اشتركت في حفل أدبي لتكريم الشاعر خليل مطران، وألقت فيه كلمة أعدتها لهذه المناسبة. قال طه حسين وهو يتحدث عن الحفل: «لم يرض الفتى عن شيء مما سمع إلا صوتاً واحداً سمعه، كان الصوت نحيلاً ضيلاً وكان عذباً رائعاً، وكان لا يبلغ السمع حتى ينفذ إلى القلب. هذا الصوت كان صوت مي».

نجمة أدبية
في سنة 1914 أصبحت «مي» نجمة لامعة في الحياة الأدبية المصرية. ومثّلت ظاهرة فريدة وجديدة لم يعرفها الأدباء والمفكرون من قبل. فهي كاتبة موهوبة، ولكنها كانت أيضاً شخصية اجتماعية لافتة للنظر، فكانت تحضر الندوات والمؤتمرات الثقافية، وتلقي المحاضرات على جمهور المثقفين، ما لم يكن مألوفاً على الإطلاق بالنسبة للمرأة العربية حتى ذلك الوقت.
العقاد.. صاحب «العبقريات» الذي عاش وحيدا بين الكتب
في تلك السنة وكانت في الـ28 من عمرها، جعلت «مي» من بيتها صالوناً ثقافياً يلتقي فيه الأدباء والمفكرون اللامعون يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ولم يكن هناك صاحب قلم إلا وشارك فيه مثل طه حسين، عباس العقاد، خليل مطران ومصطفى عبد الرازق. وظل هذا الصالون مفتوحاً بانتظام لمدة 20 عاماً ولم يتوقف إلا في سنة 1935عندما تعرضت «مي» لمحنة عنيفة.

وفاة الأب والأم
في قمة المجد الأدبي الذي وصلت إليه «مي» بدأت الأيام تتغير وتفرض عليها تجارب مريرة. كانت الصدمة الأولى في حياتها هي وفاة والدها سنة 1930 ثم توفيت والدتها سنة 1932، ووجدت «مي» نفسها وحدها لأول مرة في حياتها، بعد أن عاشت بين هذين الأبوين المليئين بالحنان لا تشعر بالفراغ ولا تحس الخوف.
ولكن وفاة الأب والأم غيرت من حالها، وبدأت تشعر بأنها كانت تعيش في حلم سعيد، وأنها استيقظت من هذا الحلم لتواجه الهموم التي بدأت تغزو قلبها بشدة وعنف.
والغريب أن «مي» عندما مات والدها لم تكن صغيرة، بل كانت في الـ44 من عمرها، وماتت أمها بعد ذلك بعامين، وكانت «مي» قد وصلت إلى السادسة والأربعين. وكانت بالإضافة إلى نضجها وتقدمها في السن مسلحة بعدة أسلحة كان من المفروض أن تنقذها من الاستسلام للمصائب التي تعرضت لها، وهي مصائب طبيعية في حياة البشر جميعاً.
وكان أبواها قد تركا لها ثروة صغيرة بالإضافة إلى ما جمعته هي من خلال كتاباتها ومكانتها الأدبية من المال، مما كان يحميها من أن تكون عرضة لأي احتياج مادي أو أخطار اقتصادية.
ومع ذلك فقد بدأ الحزن يتسلل إلى نفسها وتحيط بها الكآبة، وبدأت تميل إلى العزلة والابتعاد عن الناس. في هذه الحالة التي انتابتها أمسكت بالقلم وكتبت رسالة إلى ابن عم لها في لبنان يدعى جوزيف زيادة تشكو له حالتها التي آلت لها، وكيف أنها أصبحت مدمنة لتدخين السجائر ما أضعف قلبها.

حيلة ابن العم.. مي في المستشفى
لم يكد ابن العم يتسلم الرسالة حتى جاء إلى مصر، والتقى بـ«مي»، وأقنعها برقة ولطف أن تكتب له توكيلاً ليتصرف في شئونها ويقوم برعايتها على خير وجه. وتحت تأثير أزمتها النفسية الحادة استجابت له، وكتبت التوكيل الذي أملاه عليها، ثم أقنعها أنها بحاجة إلى السفر للبنان لتتخلص من الهموم والأحزان.
سافرت «مي» مع قريبها بالفعل وكان ذلك سنة 1936، لتتوالى الأحداث العجيبة والأليمة. كان ابن عمها طامعاً في الاستيلاء على ثروتها الصغيرة من مال وحلي، فاستدرجها إلى لبنان لينفذ خطة بالغة الشر والقسوة.
لقد أشاع أنها مجنونة، واستطاع أن يقنع البعض ممن لا يعرفون قيمة «مي» ومكانتها بأن يكتبوا تقريراً طبياً يؤكد أنها مجنونة. وبعد ذلك تمكن من اقتيادها إلى مستشفى «العصفورية»، وأقام قريبها عليها قضية «حجر» تمنعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها، واستطاع أن يحصل على قرار بهذا الحجر.
حدث هذا كله بعيداً عن العيون، وظن أصدقاء «مي» أنها تعيش فترة عزلة وانطواء، أملاً في الراحة والشفاء من أزمتها النفسية التي تعرضت لها في القاهرة بعد وفاة والديها.
وعاشت «مي» في مستشفى المجانين ما يقرب من عام، وأضربت فيه عن الطعام، فكانوا يغذونها بطرق طبية بعد أن يقيدوها بالقوة والعنف.
تحرير جزئي
ولكن الصحافة الأدبية في لبنان اكتشفت الأمر أخيراً عن طريق بعض الأدباء الذين أخذوا يبحثون عن «مي» ويحاولون معرفة أخبارها الحقيقية. هنا قامت ضجة كبيرة دفاعاً عن الأديبة الموهوبة المسجونة في مستشفى المجانين، وتدخلت السلطات اللبنانية، وكلفت بعض الأطباء بكتابة تقرير عن أحوال «مي» الحقيقية.
كتب الأطباء تقريراً يقول إنها ليست مجنونة ولا تعاني من أي مرض عقلي، ولكنها تعاني من ضعف جسدي شديد يقتضي أن تنتقل إلى إحدى المستشفيات العادية لعلاجها منه.
وخرجت «مي» من مستشفى المجانين لتدخل مستشفى عادياً آخر، وتصورت أنها ستتحرر بعد قليل، ولكنها بقيت في المستشفى الجديد ما يقرب من عام آخر. ومن هنا عادت إلى موقفها القديم من رفض الطعام والدواء، لأنها كانت تشعر بأنها مسجونة وليست مريضة.
ومرة أخرى يتجمع أصدقاؤها، ليثيروا ضجة واسعة لإنقاذها مما هي فيه، ولتخرج «مي» لتقيم في بيت خاص، وتلقى رعاية من أصدقاء مخلصين كان على رأسهم أديب لبنان الكبير أمين الريحاني الذي أعطاها هو وعائلته كل الحب والرعاية، وساعدها على التخلص من سلطان ابن عمها وسطوته، وانتهى الأمر برفع الحجر عنها تماماً وعودتها إلى حريتها الكاملة، وحقها في التصرف في حياتها وأموالها كما تشاء.
ولكن التجربة المريرة التي عاشتها «مي» كانت قد أثرت على صحتها وملأتها بالشك وعدم الثقة في الناس. والحقيقة أن هذه التجربة كانت كفيلة بأن تؤدي إلى تدمير أي شخصية مهما كانت قوتها، أو قدرتها على المقاومة.
ورغم أن «مي» حاولت أن تعود إلى حياتها الطبيعية إلا أن التجربة الأليمة كانت قد نالت منها، فظلت صحتها تتدهور حتى توفيت في 29 أكتوبر سنة 1941 ودفنت إلى جوار أبويها، وكانت في الـ55 من عمرها.